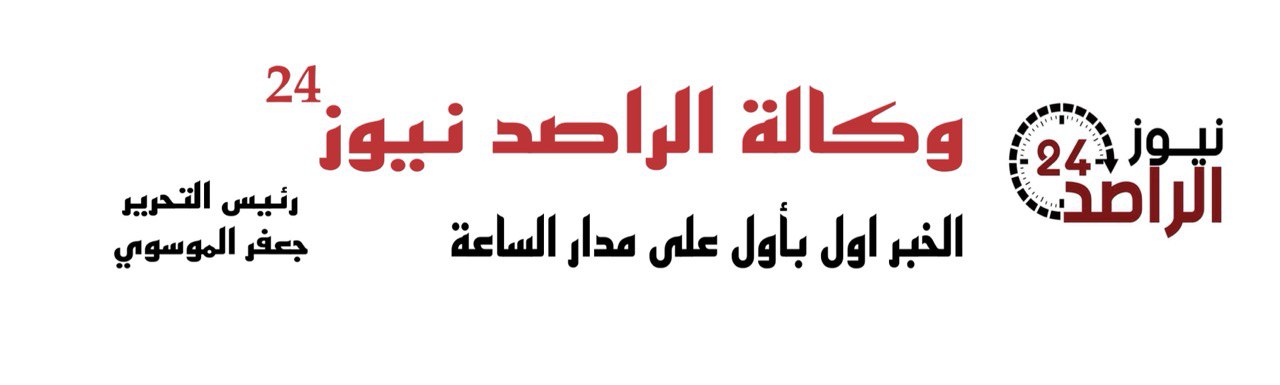عزف الرمال


قراءة نقدية للمجموعة الشعرية ( عزف الرمال ) للشاعر حسين السياب | ميادة مهنا سليمان
ناقدة وشاعرة
ثمانيةٌ وثلاثونَ قصيدةً كتب مقدّمتها النّاقد العراقي عبدالسادة البصري، أمّا الغلاف، فهو لوحة الفنان العراقي ستار كاووش
وجاء في الإهداء:
كلّ الكلمات محطّات روحي
الّتي تنتظر وجهكِ
وأنا.. أصبر كالسّنين
ورقة ورقة
وحدودي معكِ فضاء حبّ وقصيدة
ورغم ذلك فإنّ عزف الرّمال، ليست مجموعة شعريّةً عن حبّ الأنثى فقط، بل فيها قصائد حبّ للوطن، وعلا فيها صوت النّقمة والتّذمّر من حالة الفساد والطّغيان الّتي تتقاسمها البلاد العربيّة، وخصّ الشّاعر بلده بِذكرها معربًا عن حزنه في أكثر من قصيدة، بل رأيناه أحيانًا مغتربًا في وطنه.
ففي قصيدته (نهر يبحث عن ضفّة) يتساءل السياب:
هل تنتهي الأحقاد القديمة بانتهاء الحِقبِ التّاريخيّة، أم أنّها تستمرّ، وتجري جريانَ نهرٍ عرفَ منبعَه لكنّه لا يعرف أين المصبّ؟
يقول:
كيف يستقيم النّهر
في مسيره
وقد نُصِبت له الكمائن
من كلّ حدَب وصوب
وأعوانُ الحجّاج
مازالوا يتربّصونَ به
مدجّجين بالسّيوف
والأحقاد
وبينما نحن نستمتع بجريان كلمات السياب في حقول ذاكرتنا تأتينا خاتمة القصيدة لتعلن النّهاية السّوداويّة:
لا خلاص ولا استسلام
إمّا الموت على أيدي الجلّاد
أو الموت خوفًا من ليل أسدلَ ستارَه وأطبقَ فمَه
يقتصُّ من النّهر كلُّ ذنوب الأوطان
ونجد النّقمة ذاتَها في قصيدة (تسابيح الوجع)، حيثُ يعرب عن أسفه لما يسمى استمراريّة “تقديس” كلّ ما هو قديم أو متعارف عليه على أنّه دينيّ حتى لو كان هذا القديم سوطًا يدمي ظهر حريتنا:
ألف عام
ونحن نُجلد بسياطٍ مقدّسة
كما تُجلد الخيولُ
في سباق الدّهشة
والجري وراء الله
المختبئِ منّا
ويعلنُ في ختام القصيدة أنّ العدالة الإنسانيّة رغم كلّ هذا التّقديس لم تتحقّق:
فلا الأرض ظفرتْ بنور الشّمس
ولا الدّمعةُ سقطت
من محاجرِ الأيتام
نتابع مع السياب في قصيدة (قطع متناثرة)، فنجد الحقدَ على الأوغاد الّذين يدّعون حماية الوطن، وهم أنفسهم من استباحوا حرماته، وروّعوا الآمنين فيه، يقول:
وأنا أحمل الوطن
في حدقاتِ العيون
كان القتلةُ يتسلّلون
بعد منتصف كلّ ليلة
يمزّقونَ جفوني
ليسرقوا دجلةَ والفرات
ويرجموا بابلَ ويحرقوا أور والزّقّورة
ودار إبراهيم
ويلعنوا بغداد
بأعلى أعلى أصواتهم
تيمّنًا بأسلافهم من المارقين
الأوغاد
ولعلّ ما يشير إليه السّيّاب من حزن مكبوت على ما يجري في بلده الجميل وفي البلاد العربية عمومًا يطلق صرخة عبر قصائده، صرخة تهزّ الإنسانيّة وكأنّها تساؤل:
لم محتّمٌ علينا كلّ هذا الجَلد وكلّ هذا البكاء والعذاب؟
ولذلكَ نراه في قصيدته ( النّهر ) يتساءل:
عاريًا يركضُ النّخيل
إلّا منَ الخيباتِ
ليُسابقَ النّهرَ
الّذي يفرّ من أرض الله
وفي قصيدته (تسابيح الوطن) يشرح لنا مأساة “السّومريّ الحزين”، فيصفُه بأنّه يترنّح مستذكرًا وطنًا نازفًا بالجراح، تتشكّل هذه الجراح، لتُصبحَ “قصيدة نثر” وفقَ تعبيره، وربّما اختار نمط الحداثة ليعلن الثّورة على كلّ ما هو قديم وبالٍ، تبوح هذه القصيدة رغم الوجع عن تفاؤل، يقول:
والليل حتّى مطلع الفجر
يرسم الكلِم
ويؤطّرُ النّصّ بالسّواد
وبعض ألم
يصوغ من قطرات الدّم
إمضاءً لشاعر
يطوف في رأسه
سفّاحٌ
يلوّح في يده فأس
وعلى صدره نوَط خيانة
الوطن
يختم الشّاعر ديوانه بقصيدة (المشهد الأخير)، وهنا تنسجم القصيدة كخاتمة، وكمضمون، وكعنوان مع ما سبق وقدّمه في تلكَ المجموعة إذ إنّ قصيدته يعلن فيها عن فشله في إيجاد بصيص نور لهذا الوطن المُبتلى بعتمةِ القهر والاستغلال والفساد:
مازلتُ أبحثُ في كومةٍ
من ذكرياتٍ
علّني أجد بين السّطور
نورًا لقلبي
يُبقيني معلّقًا في الطّرقات
كضوء لا ينطفئ
تطاردني وجوه القتلَة المأجورين…
ثمّ تزداد نبرة الأسى والسّوداويّة في المقطع الأخير:
مازالت الكواتمُ تُطاردُ الرّؤوس
الّتي ينمو فيها الوطن حرّاً
بلا قيود
”مازالَ القاتلُ مدجّجًا بكلّ آلاتِ
الموت والرّؤوس المغدورة
تبحث عن وطن
تجدُ فيه قبرًا باردًا”
وفي عزف الرمال لدى السّيّاب تتفاوت الألحان ولكنّنا نجد العزف الأعلى صوتًا في قصيدته (جنون بصوت الملائكة):
تمتمات ملائكة وشياطين
وموسيقى جنائزيّة تصدح
تشيّع النّوم
إلى مثواه الأخير
مكتظّة ليلتي بالأشرطة
السّود
وهكذا إلى ختام القصيدة في المقطع الأخير:
والعائدون من الجحيم
خطاهم مثقلة
وجوههم مشوهة
أرواحهم ساكنة
منزوعة القلوب
يجوبون الشّوارعَ
الكئيبة المهجورة
فلا بيوت تأويهم في المدينة
المرعوبة
سقطوا سهوا
من نافذة النّسيان
سقطوا سهواً من نافذة الجحيم’
وكما ذكرتُ في البداية أنّ للحبّ نصيبه في المجموعة، ولكنّ السياب كان في قصائده عن الوطن محلّقًا كنسرٍ، وكان عزفُهُ صاخبًا، بينما كان في قصائد الحبّ كعصفورٍ يزقزقُ على فننِ الشّوق، يقول في قصيدة فنون اللؤلؤ:
أقلّب في دفاتر
الذّكريات
أستلّ منها كلمات الحبّ
أصيغ من حروف اللغة
قلائد فضّة
وسوارًا يليقُ بكِ
ونظراً لتفاوت المستويين الإيقاعيّين ما بين صاخبٍ وخافتٍ برأيي كان الأفضل لو جعل المجموعة فصلين:
أوّلاً مع العزف الهادئ، وفصل الحبّ، ثم تعلو النّغمات، فيأتي فصل للوطن، حيث تعلو ألحان العزف، لكن ربّما أراد السّيّاب دمج الألحان كلّها، ليظلّ خارجًا عن المتعارف عليه، في عزفٍ اختاره بطريقة اللا مألوف، فكلّنا نعرف أيّ سيمفونيّةٍ يمكن أن نسمع حين تثورُ الصّحراء وتقرّر رمالُها العزفَ.
الهويّة العراقيّة في المجموعة:
حفلت المجموعة بكلمات تدلّل على الهويّة العراقيّة، منها:
1–أنهار:
حيثُ ذكرَ الفرات ودجلة.
2–المدن:
–بغداد، الّتي تأسّست عام 762م لتكون عاصمةً للخلافة العباسية، وكانت على مدى 500 عام أهم مركز ثقافة للحضارة العربية والإسلامية.
-بابل، أو “بَوَّابَة الْإلِه” إحدى مُدن العالم القديم، وأكبر عواصم حضارة بِلادُ الرافِدين. تقع على ذراع نهر الفُرات، وقد أدرجتها مُنظمة اليونسكو على لائحة التُّراث العالمي.
3–أماكن تاريخيّة:
–أور الزّقورة:
تعدّ زقّورة أور من أقدم المعابد الّتي بقيت في العراق، تقع على نحو 40 كم إلى الغرب من مدينة الناصريّة بناها الملك السّومريّ (أور نمو) مؤسّس سلالة «أور».
–دار إبراهيم:
يعدّ دار النّبيّ إبراهيم الخليل أحد أهمّ المواقع الأثريّة في محافظة ذي قار، ويقع بالقرب من زقّورة أور، ويعود تأريخ بنائه إلى نحو ستّة آلاف عام قبل الميلاد.
4–حضارات:
–الحضارة السّومريّة:
من الحضارات القديمة المعروفة في جنوب بلاد الرافدين، وقد عرف تاريخها من الألواح الطينيّة المكتوبة بالمسماريّة.
–أكد:
ازدهرت هذه الحضارة خلال الفترة 2200 – 2400 ق.م ووصلت ذروتها، عقب غزو سرجون الأكدي الّذي في عهده تمّ فرض اللغة الأكديّة لفترة وجيزة على الدّول التي تمّ فتحها مثل عيلام وجوتيوم.
5–أساطير:
عشتار:
وهي إلهة الحبّ والجمال، الحرب والتّضحية بالحروب عند حضارات منطقة بلاد الرافدين ونواحيها.
6–أشخاص:
–الحجّاج:
أبو محمّد الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ (40 هـ/660 م – 95 هـ/714 م)، قائد وسياسيّ أمويّ، وُلِدَ ونَشأَ في الطّائف، بنى مدينة واسط ومات بها، وكان سَفَّاكاً سَفَّاحاً مُرْعِباً باتِّفاقِ مُعْظَمِ المؤرّخين.
–أبو نُواس:
الحسَنُ بنُ هَانِئُ، شاعر عربي، يعد من أشهر شعراء عصر الدولة العباسية ومن كبار شعراء شعر الثورة التجديدية. وُلد في الأهواز سنة (145هـ / 762م). ونشأ في البصرة، ثم انتقل إلى بغداد.
*بالإضافة إلى تكرار كلمتي نخيل، ونهر
فالنّخيل كان قديمًا جزءًا من الصّورة الشّعريّة، ولا ننسى كم حظيَ بمكانة عالية في العصر الجاهليّ، وقد كانت النّخلة رمز الخصوبة والأنوثة، وكما يقول الكاتب أنور أبو سويلم في كتابه( مظاهر الحضارة والمعتقد في العصر الجاهليّ):
“لذلك كانت النّساء في ذلك العصر يضعن ثيابهنّ وحليهنّ على جذوع النّخل ابتغاء للذرّيّة من الآلهة عشتار”.
يقول السياب:
يولد في قلبي نبع صغير
تقبّلني نخلة على خدّي بافتتان
مغطّيًا إيّاها بشوقٍ
ودمع فاض من عينيّ
حينَ رحل النّهر بعيداً
أمّا النّهر، فهو من الرّموز الّتي وجد فيها الشّعراء دلالات وإيحاءات خصبة للتّعبير عن أفكارهم، وهو التّحوّل، الحركة، الاستمراريّة، الحضارة المزدهرة، فلا ننسى أنّ معظم الحضارات نشأت حول الأنهار ومجاري المياه
وهو الوجه الآخر الحياة فإن جفّ هو الرّكود والظّمأ والجمود.
وورد لدى السّيّاب قصيدتان بعنوان:
(نهر يبحث عن ضفّة، النّهر)
عدا عن ورود الكلمة في العديد من القصائد:
”سلاما لشمس
تشرق على بغداد
تغازل النهر
تلاعب موجة هاربة من الضفاف”
“يلتهم فم الحياة
نوارسَ دجلة
التي تمارس بدعة الطواف
بين الجسر والنهر”..